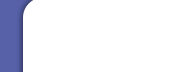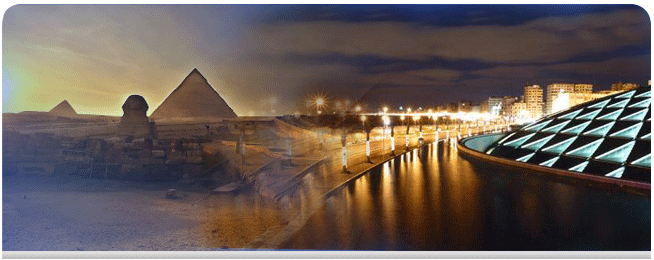|
ألقى كل من الأستاذة / هدى أنيس سراج الدين رئيس الجمعية
المصرية لحماية الملكية الفكرية والسيد اللواء / هيثم حمودة
نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والسيدة المهندس / عصمت
عبد اللطيف رئيس مكتب براءات الاختراع وسعادة السفير/ أمجد عبد
الغفار مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية
للملكية الفكرية الكلمة الافتتاحية للندوة.
وقد نوهت الأستاذة / هدى سراج الدين على أهمية إجراء مراجعة
لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وذلك في ضوء نتائج
تطبيق القانون خلال السنوات السابقة، وخاصة في مجال براءات
الاختراع والعلامات التجارية. وبالنسبة للتطور في المجال
القضائي، أشادت الأستاذة / هدى سراج الدين بتجربة إمارة دبي
الرائدة في إنشاء محاكم متخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بحقوق
الملكية الفكرية، وضرورة الاستفادة من هذه التجربة. وقد أكد
اللواء / هيثم حمودة أن مصر من أوائل الدول العربية التي أصدرت
تشريع لحماية حقوق الملكية الفكرية بإصدارها قانون رقم 57 لسنة
1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ومسايرة المشرع
المصري للتطورات العالمية وانتهاء بإصدار القانون رقم 82 لسنة
2002، وهو قانون موحد لحماية حقوق الملكية الفكرية بالإضافة
إلى انضمام مصر لمعظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية
الفكرية.
وقالت المهندس /عصمت عبد اللطيف أن الحماية القانونية تشجع
وتتابع تطور الإنسانية والابتكارات البشرية وتسبغ حمايتها
للمخترعين والمبتكرين بما يساهم في استمرار عجلة التقدم
والتنمية. وقالت أن مكتب البراءات المصري، في سبيل النهوض
بدوره وزيادة كفاءته، يقوم بعقد اتفاقيات تعاون وتدريب مع
المنظمات الدولية ومراكز البحث المتقدمة. وقد توجت تلك
المجهودات بأن أصبح مكتب البراءات المصري هو إحدى المكاتب
الأربعة عشر في العالم المنوط بها عمل الفحص التمهيدي والبحث
الدولي وذلك بالنسبة للطلبات المقدمة باللغة العربية.
ودارت كلمة السفير/ أمجد عبد الغفار حول دور المكتب الإقليمي
للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية في التعاون
مع الدول العربية لمعرفة احتياجات الدول العربية في مجال
الملكية الفكرية وتطوير النظم القانونية وإدارات التنفيذ فيها
وشدد على ضرورة اشتراك مصر والدول العربية في المحافل الدولية
بدور فعال لحماية مصالحها وإنشاء مراكز نقل التكنولوجيا
بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على غرار
التجربة التونسية.
|